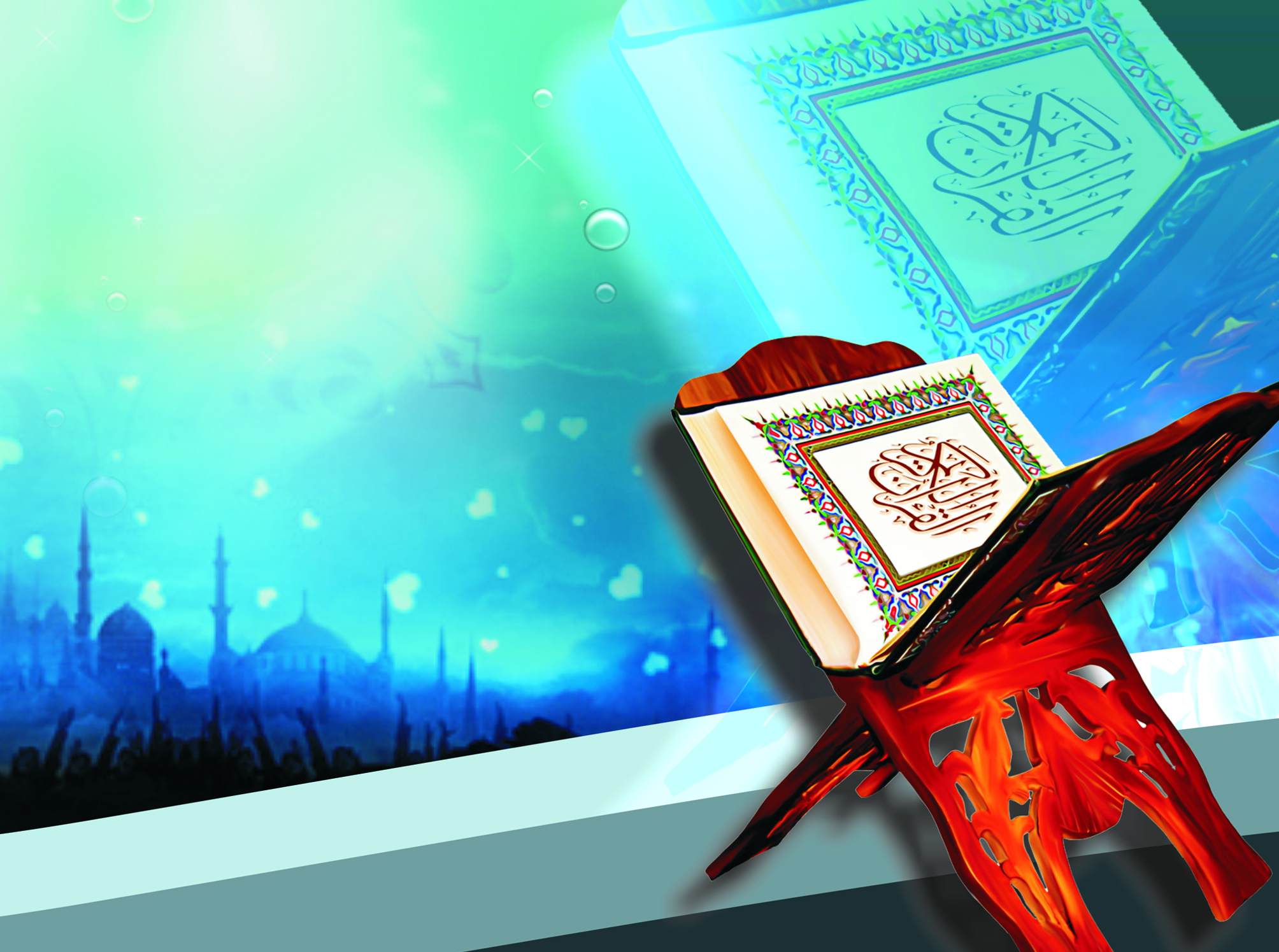مما لاشك فيه أن القرآن الكريم قد خاطب الناس جميعاً منذ نزوله إلى يوم الدين وهو بذلك الكتاب الإلهي المتفرد الأوحد الخالد المعجز الذي بقي ببقاء السماوات والأرض وفيه تبيان كل شيء.
ونقف بدءاً بتعريف (سبب النزول):
فهو الأمر أو الحادثة التي يعقبها نزول آية أو آيات في شخص أو واقعة… أو هو (ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه مبينة لحكمة أيام وقوعه)(1).
فأسباب النزول تعطيك الظرف الخاص الذي تنطلق منه الآيات الشريفة إلى الظروف العامة فقد يكون الظرف خاصاً فيصعد فيكون عاماً… وربما تكون حادثة وإن الأسباب ليس ما قيل فيها هي الحقيقة وذلك لخضوعها للاجتهاد وتنوع الرواة والروايات مما يعطيها تنوعاً في الاحتمال والأطروحة.
ويذهب بعض المفسرين إلى امتناع تفسير الآية وقصد سبيلها من دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها(2).
وعليه ـ فهذه الأسباب هي تابعة لعلوم القرآن، ومن هذا المنطلق فهي تخدم العبارة التفسيرية كما أن التفسير يقوم بإغنائها وإعطائها بعداً قرآنياً، وعندها فالحادثة التاريخية تتعاضد مع النص القرآني فتكتسب الحادثة امتداداً لا نهائياً في التطبيق والواقع. فتاريخية الواقعة هي العنصر المبرز في تثبيت أسباب النزول دعماً للحركة التفسيرية للنص.
وسياق النزول هو الأهم في الدلالة القرآنية ذلك أنه تأتي آية بعد آية تعطي ضوءاً في معناها وهذا من النظم الفني والتناسب فضلاً عن العلائق والقرائن الأسلوبية الأخرى.
فالمفسر يعتمد على سياق التدوين ومن المعاصرين من يعتمد على سياق النزول ولكن المفسر إذا اطلع على أسباب النزول وتاريخ النزول فبإمكانه أن يعتمد على السياقين معاً… بما يقوي مقدرته المعرفية وكفايته التفسيرية في فضاءات النص المبين.
فإذن يجب في معرفة غرض كل سورة من معرفة تاريخ ومكان نزولها من مكة أو المدينة لأن نزول السور كان يراعى فيه الزمان والمكان حتى تستقي مكامن الأصول الاعتقادية ومواضع المقاصد الشرعية التي احتوتها الآية أو الآيات النازلة وعلاقة هذه بالأحداث المحيطة والأمور المتعلقة والأشياء المستجدة وغيرها. فقد تكون سورة واحدة فيها آية مدنية، لذا فإن الإحاطة والاستقصاء بهذه الدقة في الموقعية أو بتلك الإحاطة في التنظير السياقي ينبغي معرفتها ورصدها بتأمل حتى نتمكن من الاقتراب حول المعنى المقصود لأن مثل هذه الإشارات المرجعية تعد دلائل بيانية مهمة في تفسير النص القرآني وتحليل علائقه العميقة.
ومن هنا فالمهم في هذه الأسباب هي أنها تمثل الشواهد القرآنية من الحدث والحكم وهي قريبة من الآية لكونها قريبة للكشف والتفسير إذ تتظافر هذه مع القرائن الأخرى أي أن (القرآن وهو أسمى نص عربي يرصد من القرائن الحالية التي تتمثل في أسباب النزول ومن القرائن المقالية التي تتمثل في تراكيب النص وفي الآيات التي تفسر آيات أخرى ما يحول بين البيان وسياقه الكريم…)(3).
والقرائن الحالية هي الظروف المحتفة بيئياً وتاريخياً بنزول النص القرآني إذ أنها وثيقة صلة بالمقتضي الذي نزلت الآية بموجبه.
أما مقتضى الحال أو الصورة المخصوصة التي تشاكل غرض المتكلم فهو ما يدعو إليه الأمر الواقع أي ما يستلزمه مقام الكلام وأحوال المخاطب من التكلم على وجه مخصوص ولن يطابق الحال إلا إذا كان على وفق عقول المخاطبين واعتبار طبقاتهم في البلاغة وقوتهم في المنطق والبيان(4).
ومن ملاحظة المعاني والدلالات القرآنية نجد أن سبب النزول هو مقتضى الحال الذي عليه مدار علمي البيان والمعاني اللذين يعرف بهما إعجاز القرآن كما أشار إلى ذلك العلامة المفسر الزمخشري في مقدمة كشافه… ومن هنا فالكلام الواحد يختلف استيعابه وتلقيه بحسب الأحوال أو المخاطبين، وهذا يعني أن الخطاب القرآني يشتمل على أسباب تنزيل وعلى تطبيق إلهي وعلى مجتمعات من بني الإنسان خارج حدوده الزمنية فلابد أن يشير إلى تعدد المعاني بتعدد المواقف.
وبهذه الأسباب الداعية إلى الحكم وهي التي جاءت بمثابة إضاءة تفسيرية يحملها النص القرآني معه وهي إضاءة قريبة جداً فليس هناك من القرائن أقرب منها إلا تفسير القرآن بالقرآن ـ تتبين مناسبة النزول إذ يكشف بها عن غموض الآية كما قد تكشف الآية عن غموض في المناسبة من ناحية تاريخية ودلالية لذا أوضحت هذه الأسباب كثيراً من الآيات التي جهل المسلمون بادئ الأمر مفادها ومغزاها.
نعم، فجميع هذه القرائن التفسيرية تدل على أن القرآن الكريم كامل مفصل غير متناقض صالح لكل زمان ومكان فكأنه أعد إعداداً معيناً لهذه الأزمنة المختلفة بسياقه ونظمه وإعجازه.
لقد تعددت أسباب النزول والروايات حولها لتعدد الآيات واختلافها مما أوجد بين الدلالات القرآنية وجوهاً للاحتمالات والافتراضات التفسيرية التي لا تقبل الترجيح والتفاضل أحياناً لأننا لا علم لنا بذلك العصر النزولي فقد تتشابه روايتان وهما تتعلقان بسبب واحد فنقف إزاءهما ونحن لا نملك الدليل القاطع على الأقرب والأصح في دلالة الآية الكريمة(5)، وهذا يتفق مع (معنى قول العلماء: إن المرويات في أسباب النزول يكثر فيها الوهم…)(6)، وذلك لتغلغل الإسرائيليات في كثير منها…
وقد أوردت الدكتورة عائشة عبد الرحمن نماذج مختلفة منها… ومن المفسرين من وجد أن هذه الأسباب (ما هي إلا مناسبات لا أسباب حقيقية وإن سميت أسباباً على طريق التسامح والتجوز لأن هذه الأسباب هي ملحق من ملاحق علوم القرآن بمعنى أنها غير أصيلة في الوحي بل هي قرائن معينة ومساعدة من مجهود بشري يصيب ويخطئ بخلاف التنزيل الذي هو على الحق دائماً.
ومن هنا فإن العلماء متفقون على أن ما يدل عليه الكلام القرآني هو الذي يؤخذ به على ما في دلالته من شمول واتساع لا يضيق منهما مراعاة الملابسات الظرفية التي اتصلت بتاريخ نزوله وهو معنى قول علماء أصول الفقه: (إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)(7).
فالعموم من مختصات اللفظ كاسراً بذلك خصوص السبب النازل نظراً لجريان القرآن وخلوده لذا لا تخصيص في موارده بل الأحكام عامة إلى ما شاء الله…
وبيان قول علماء الفقه نقول: إن المفسر يرى أن قولنا (سبب) يعني أن هناك (مسبباً)… فعلى سبيل المثال نقول:
الشمس سبب النهار معناه: لا نهار إلا بالشمس في حين لا نستطيع أن نقول: (لا قرآن إلا بهذه الأسباب) يعني أن السببية فيها ليست بمعنى العلية المنطقية التي تلزم أن لولاها ما نزلت الآية وإنما العبرة بعموم اللفظ المفهوم من صريح نصها لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه(8).
والحق أن هذه الأسباب هي ظروف نزول الآية لذا عبر عنها بـ(المناسبات) وهي التي يستوضح موضوعها من حكم النظم القرآني أو من موضوع النظم القرآني يستوحى حكمها…
ولكننا نعم أن ترتيب النزول هو ترتيب إلهي لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر به (كأن تكون آيتان نزلتا في وقت واحد ألحقت إحداهما في سورة والأخرى في ثانية)، فمن هنا نقول: إن الكتاب الذي لاشك فيه ـ وهو بين أيدينا ـ من الأدرى بوضع سوره وآياته ونظمها وترتيبها قبل أن يكون إبلاغاً في حسن بيان أو قبل أن يكون كتاباً تجمعه الدفتان(9)…؟
إذاً فعله سبحانه وتعالى كان في نطاق الوحي بنزول آيات وسور قبل أخرى أو بعدها بحسبان معناه في عموميته لا في جزئياته، هذا يعني كما يقول الأستاذ عبد المتعال الصعيدي: (لو لم يكن ترتيب القرآن على خلاف أزمنة نزوله ـ لأجل وضع الآية بجانب ما يناسبها من الآيات لكان العدول عن ترتيبه على أزمنة نزوله إلى هذا الترتيب خالياً عن الحكمة وهذا محال على الله تعالى)(10)، لأنه في المرتبة الأعلى من الحكمة.
ولبلاغة القرآن تجدد مستمر وذوق رائق ومزية فائقة، من هنا فقد أورد المفسر ابن عطية الحوار الآتي:
(فقد قيل لجعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): لِمَ صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منها، والقرآن لا يمل؟ فقال: لأن القرآن حجة على أهل الدهر الثاني كما هو حجة على أهل الدهر الأول فكل طائفة تتلقاه غضاً جديداً ولأن كل امرئ في نفسه متى أعاده وفكر فيه تلقى منه في كل مرة علوماً غضة وليس هذا كله في الشعر والخطب)(11).
ولأنه بلاغ مبين ستبقى معانيه تتجدد إلى ما شاء الله وسيبقى معها لا تبلى جدته يخاطب الناس في جميع أحوالهم وظروفهم وأزمنتهم لعموميته فلابد أن يشير إلى تعدد المعاني بتعدد المواقف أي أنه مستوعب كامل مفصل صالح لكل زمان ومكان.
ومن جهة تحليلية فالخطاب الإلهي يكون على نحو القضية الحقيقية وهي تلك القضية التي لا تلاحظ المشخصات أو المميزات في كل الأفراد وإنما تلاحظ القاسم المشترك أو القانون الكلي الشامل للموجود الفعلي أو المعدوم الفرضي…
وهذا يأخذ بنا إلى القول: إن السمة البيانية الكلية الموجودة في القرآن الكريم تقترن بها المناسبة المتطابقة مع الظرف من جهة ومع السمة العامة من جهة أخرى بمعنى أن هناك خصوصية في الآية وعمومية تجعل من خصوصيتها في (المناسبة التي نزلت من أجلها) عمومية تجري مع الأجيال والزمن لوجود علاقة المشابهة مع المناسبة المقصودة التي نزلت فيها الآية قرينة على صحة التبعية في الانطباق، فأصبح ذلك تيسيراً عند المفسر بأن يجري الحكم القرآني الذي كان على الماضين فيطبقه على المعاصرين لأن القرآن الكريم بيان للعالمين الأولين والآخرين.
وخلاصة القول:
إن أسباب النزول مهمة جداً في استجلاء العلائق الدلالية ومعايير النظم فمنها تستوضح الآية إذا كان ظاهرها لا ينبئ عن معناها في تحديد الزمان والمكان أو الاقتراب من المنحى التاريخي للنص، وبها نكون قد أخذنا جانباً جلياً في قضية التفسير البياني لاستنطاق الجوانب المهيمنة عليه والكاشفة عنه حينذاك…
والحمد لله أولاً وآخراً… >
—————————————————————————————————————————